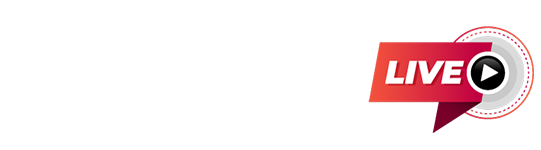فبعد تدهور أوضاعه، لم يعد شغل المصنع الشاغل هو إنتاج الأسمنت بجودة تنافسية، بل تحوّل إلى منصة رئيسية لاستقبال وتجميع وتوزيع الفحم البترولي، تلك المادة الخطرة التي تثير رعب المتخصصين في البيئة. الميناء الواقع داخل حرم المصنع، والذي كان مخصصاً لاستيراد مواد أولية أخرى، أصبح البوابة الرئيسية لدخول أطنان من هذه المادة السوداء. الشاحنات تتوالى، والناقلات تتراصف، والعملية لم تعد مجرد « شحن » عادي، بل هي عملية متكررة من « التفريغ والتكديس » تحوّل معها المكان إلى مستودع مفتوح، حيث تطير الذرات الدقيقة من الفحم مع كل نسمة هواء، لتدخل البيوت، وتستقر في الرئات، وتلوث المياه والأراضي.
الخطورة لا تكمن فقط في تحوّل المصنع إلى مركز لوجستي لتزويد المصانع الأخرى بهذه المادة، بل في الطبيعة الكيميائية للفحم البترولي نفسه. فهو ليس كالفحم العادي، إذ يحتوي على نسبة عالية من الكبريت والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات المسببة للسرطان. غباره لا يسبب فقط أمراضاً تنفسية كالربو والحساسية، بل يمتد تأثيره ليصيب القلب والجهاز العصبي، ويُسمم التربة والمصادر المائية لسنوات طويلة.
أصبح سؤال « ماذا كان يصنع في المصنع سابقاً؟ » يتردد على ألسنة القدامى من السكان بحسرة. لقد تمت التضحية بسلامة المجتمع وصحته على مذبح الربح السريع والتعافي الاقتصادي للمصنع المتدهور. لقد تم استبدال صناعة كانت مصدر فخر، بأنشطة تحويلية جعلت من المنطقة « منطقة تضحية » تتحمل عبء التلوث من أجل مصانع أخرى تقع في أماكن أبعد.
الغريب في الأمر هو هذا الصمت المطبق، أو شبه المطبق، رغم تعدد مرات الشكوى. يبدو أن صفارات الإنذار التي يطلقها السكان لم تصل بعد إلى آذان من بيدهم القرار، أو وصلت واختلطت بضجيج الآلات وصافرات الشاحنات. المعاناة الحقيقية هي في أن ترى الخطر يزحف إلى عتبة دارك كل يوم، وتصرخ طالباً النجدة، فلا يسمعك أحد.
في الختام، قضية الفحم البترولي في هذا المصنع ليست مجرد قضية بيئية عابرة، بل هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى. إنها اختبار حقيقي لمدى أولوية صحة المواطن وسلامته في معادلة التنمية الصناعية.
إن التغاضي عن هذه المعاناة، تحت أي ذريعة، هو إعلان ضمني بأن الربح المادي قد أصبح أغلى من الإنسان نفسه. ولا يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة إلا بصرخة جماعية واحدة: كفى.
أبو جوليا